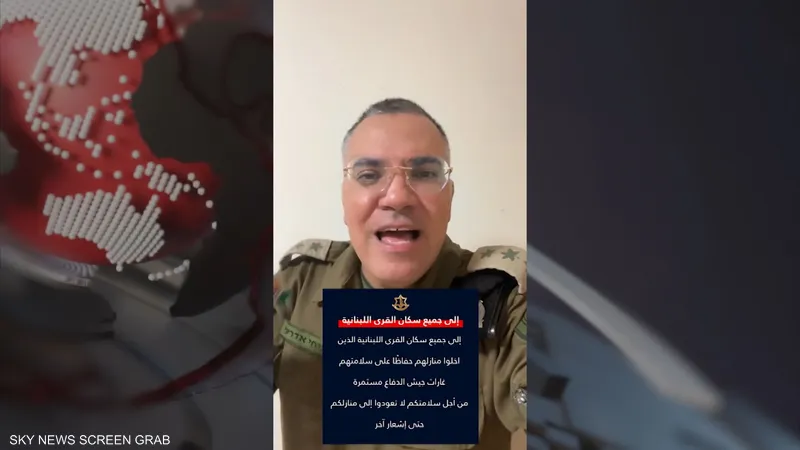وليد جنبلاط غيّر قواعد اللعبة برمتها… أتعب الجميع ولم يتعب: “ليس الدروز من يبكون شهداءهم”!

في 16 آذار من العام 1977، ذلك اليوم الأسود من تاريخ لبنان المعاصر، الذي إغتيل فيه “المعلم” كمال جنبلاط، الزعيم والمفكر والفيلسوف والسياسي الاستثنائي، كان نجله الوحيد وليد في منتصف العشرينيات من عمره، بعيداً كل البعد عن السياسة والحياة الحزبية وعن يوميات زعامة “المختارة”. كان كأبناء جيله، يعيش شبابه بحرية، بعيداً عن كل القيود كونه إبن واحد من أبرز الزعماء اللبنانيين.
عندما جاءه النبأ المزلزل، كان وليد في بيروت، إتجه فوراً إلى الجبل، حاملاً في قلبه حزنه الكبير، وقلقه الأكبر. شعر منذ سماعه خبر الاغتيال، وهو العارف بتقاليد الزعامة “الجنبلاطية” وأعرافها وكذلك خصوصية طائفة الموحدين، أن القدر إستدعاه على الفور، ليخلف والده الشهيد، من دون أن يكون قد تهيأ أو استعد، لا نفسياً ولا سياسياً لهذا الحمل الثقيل الذي يزن جبال الشوف، وسيلقى على كتفيه، فتيقن من لحظتها أن حياته كلها قد تغيرت، وسيحرم من فترة شبابه، التي كان يعيشها مع أصدقاء من عمره.
وصل إلى قصر المختارة، هاله مشهد الجموع الغاضبة الساخطة الباكية، التي زحفت من الشوف وعاليه، كتعبير عفوي لوضع نفسها بتصرف “المختارة” ليس للمبايعة أو التأييد لـ”سيد القصر” هذه المرة، بل ثأر له.
وقف وليد جنبلاط المفجوع، متمالكاً نفسه، محافظاً على رباطة جأشه، وأطل بقامته الفارعة، مهدئاً من روع هذه الجموع، قائلاً: “ليس الدروز من يبكون شهداءهم”.
إزداد قلقه، مع تتابع الأنباء عن أعمال ثأرية ضد الأبرياء في القرى والبلدات المسيحية المجاورة، على الرغم من معرفة الجميع أن المتهم بجريمة الاغتيال، هو النظام السوري، خصوصاً وأن الشهيد الكبير، كان يشعر بأن ساعة رحيله قد دنت، وأن قرار الاغتيال إتخذ، وهو ينتظر ساعة التنفيذ!
كان عليه في ذلك اليوم الصعب، لا بل ربما الأصعب، أن يتخذ أول قرار سياسي له، بصفته نجل الشهيد فقط، بأن يوقف بصورة فورية الأعمال الثأرية، فجال برفقة شيخ العقل الراحل محمد أبو شقرا مع عدد من القيادات الحزبية على القرى المسيحية، للتصدي لأي تهور من شأنه أن يؤجج صراعات طائفية بين أبناء الجبل، فأثمرت تلك الجولات فعلاً عن حماية القرى المسيحية، بعد تعرض العديد منها إلى إعتداءات أسفرت عن سقوط ضحايا.
منذ تلك اللحظة، أدرك وليد جنبلاط أن القدر قذفه إلى داخل نيران الحرب اللبنانية، بعدما ألبسه شيخ العقل بمباركة الهيئة الروحية للطائفة عباءة “زعامة المختارة”، خلفاً لوالده، وسط جموع العمائم البيض، متخطياً أي تردد أو تفكير، أو حتى الحذر، وهو يعلم جيداً تاريخ هذه الزعامة التاريخية، التي كان مصير العديد ممن تبوأها من أجداده القتل، وآخرهم جده ووالده.
لم يُدِر وليد جنبلاط ظهره لقدره، (وقتها لم يكن قد تمرس في “التقلبات السياسية)، بل اقتحم ذلك القدر بأسلوبه غير التقليدي، وسط بيئة شديدة التمسك والتشبث بالتقاليد، حتى بات خلال سنوات معدودة، وطيلة عقود من الزمن، واحداً ممن يصنعون قدر لبنان، بعدما كان القدر نفسه، قد دفعه الى الانخراط في “دهاليز” السياسية اللبنانية، من دون أن يسعى إليها، ولا حتى كان يرغب فيها.
الأيام الأربعون، منذ إغتيال المعلم، كانت الأصعب والأسرع سياسياً في مسيرة وليد جنبلاط الطويلة، التي حمل خلالها نعوشاً كثيرة، لأن موسم الاغتيالات والتصفيات السياسية، بدأ بكمال جنبلاط، ولم ينتهِ برفيق الحريري.
خلال تلك الأيام المعدودة، دفن والده، ودفن معه في القبر نفسه حزنه وغضبه، وتسيّد قصر المختارة، وترأس الحزب “التقدمي الإشتراكي” ثم “الحركة الوطنية اللبنانية”. حينها إتخذ القرار السياسي الأسرع والأجرأ، الى حد التهور أو الانتحار، الذي ما كان يمكن لغير وليد أن يتخذه، وهو مصافحة حافظ الأسد، المتهم الأول وقتها، بتصفية كمال جنبلاط.
لقد أدرك مبكراً مفاتيح اللعبة السياسية، بكل تناقضاتها وتحولاتها وغرائبها، التي لا مكان فيها للعواطف ولا للمبادئ، بل إن من يقرر سلوك طريقها، عليه أن يجيد تفكيك الألغام وتدوير الزوايا، متجاوزاً المثل والقيم التي لا مكان لها في السياسة اللبنانية، لا سيما وأنه بات زعيماً لطائفة صغيرة، لعبت دوراً كبيراً في تاريخ لبنان السياسي، ومطلوب منه أن يبقيها في موقع القرار، من خلال إعتماد الحكمة والشجاعة في آن معاً، لمواجهة العواصف الكبرى.
كذلك، فهم أن السياسة في لبنان، متحركة ومتبدلة، تقوم على المصالح والأنانيات والتسويات والصفقات، ما يتطلب ممن يتعاطى بها ومعها، أن يتحلى بالواقعية و”البراغماتية”، ليضبط حركته وأداءه على إيقاعها، من دون التخلي عن الثوابت، ولو ظاهرياً. وبدأ يفرض إيقاعه السياسي والزعاماتي، إنطلاقاً من هذه المفاهيم، التي عرف وبجدارة وكفاءة، كيف يتكيف معها.
لم يحاول أن يكون نسخة طبق الأصل عن كمال جنبلاط، فالراحل بإعتراف الجميع، شخصية إستثنائية على كل الصعد، ليس بمقدور من يخلفه أن يكون شبيهاً له، ولو كان نجله، بل أقصى ما يمكن فعله أن يتأثر بفكره وفلسفته وطروحه، ويقر بأنه ليس بمقدوره التمسك والالتزام بها.
شغفه وحبه الشديد للقراءة والمطالعة والمعرفة منذ “طلعته” (لازمته طيلة حياته)، كانا سبباً أساسياً في سرعة تعمقه بالمعرفة والثقافة السياسية محلياً وإقليمياً ودولياً، وملماً بطريقة تفكير الدول العظمى، وممتلكاً نظرة وتحليلاً مختلفاً عن السياسيين النمطيين، ليبني مواقفه وخياراته، حتى ولو كانت من خارج السياق والمألوف، مستفيداً أيضاً من إستعانته بمن أحاط نفسه بهم، ممن كانوا من الحلقة الضيقة في مجلس والده، علماً أنه في الوقت نفسه، إستغنى عن عدد منهم، لأنهم لم “يركبوا” مع مزاجه الصعب!
صاغ لنفسه شخصية سياسية لا تشبه إلا وليد جنبلاط نفسه، واستطاع بسرعة متناهية فرض نفسه على بيئته الدرزية، وتحديداً رجال الدين، وفي أوساطه الحزبية، وعلى حلفائه وخصومه في آن معاً.
لم يستغرق وقتاً طويلاً حتى تكتمل شخصيته السياسية، وحتى يتبلور أسلوبه السياسي المتميز بغرابته عن أداء كل السياسيين، حتى بات لاعباً أساسياً في كل المراحل التي واكبها من تاريخ لبنان المعاصر.
على الرغم من كل المتغيرات والتبدلات، التي لم يكن في مواقفه أقل سرعة منها (!)، بقي وليد جنبلاط ثابتاً وراسخاً الزعيم الأقوى في طائفته، منذ اللحظة الأولى بعد إستشهاد “المعلم”، ما سهل عليه أن يكون ممثلاً عنها على الصعيد الوطني.
كان حاضراً دوماً وبقوة في كل حدث، ليتحول في بعض المحطات المفصلية هو نفسه الحدث، إن كان أيام الحرب وأيام السلم، جامعاً بمهارة القادر ما بين المصلحة الوطنية (من وجهة نظره)، ومصلحة طائفته وحقوقها، ولم يكن يتأخر عن أن يفتعل أزمات سياسية ويطلق مواقف تصعيدية بشأنها، حتى يحصل على مبتغاه، وينتزع ما يريد لها من حقوق ومكاسب.
في زمن الحرب، كان وليد جنبلاط في قلب المعركة، حاضراً بقوة في كل الحروب التي خاضها، أو التي فرضت عليه، كمقاتل شرس، دفاعاً عن وجود طائفة الموحدين ومصالحها، بارعاً في عنونتها بشعارات كبيرة، تحاكي العنفوان الدرزي، كي يحافظ على دعم أبناء الجبل ومساندتهم في تلك الحروب، والذين لم يتوانوا عن تلبية ندائه لخوض المعارك، إيماناً منهم بأن زعامة المختارة، تحاكُ بخيوط النضال، ومواقف الرجال، عبر الأيام والتاريخ والأزمنة.
ومن بين تلك الحروب التي خاضها، تبقى بالنسبة اليه، معركة الجبل، هي أم المعارك، والحرب الأهم بنتائجها السياسية والوجودية على صعيد الطائفة وعلى صعيد فرض نفسه منذ ذلك الوقت أحد أبرز قادة الحرب، ليصبح لاحقاً أحد اللاعبين السياسيين.
في تلك الحرب التي إنتصر فيها عام 1983 (بدعم عسكري سوري وفلسطيني)، أعاد جنبلاط سيطرته على الجبل (تحقيقاً لحلم تاريخي)، بعدما هيمنت عليه ميليشيات “القوات اللبنانية” في عهد الرئيس أمين الجميل، مستفيدة من الاحتلال الاسرائيلي، فشكل هذا الانتصار منعطفاً تاريخياً، غيّر قواعد اللعبة برمتها، وتكرّست زعامة وليد جنبلاط منذ ذلك الحين، كرقم صعب في المعادلة السياسية اللبنانية.
زياد سامي عيتاني- لبنان الكبير